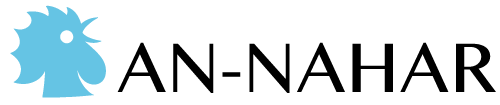الوصف اللائق
لو كان في مقدوري أن أشلّ سلطان الاستبداد الذي يضع يده على لبنان وسوريا والعراق ومصر وفلسطين، والعالم العربي برمّته، وأن أجعل بلادنا جنّة للعدالة الأرضية، لما كنتُ تأخرتُ. ولو كان في مقدوري أن أكتب، هنا، الترف الأدبي، أو أن أهرب فيه، لكنتُ اخترتُ أن أكتب العيش لبلادي في هذه اللوحة، مثلاً، لا في "رائحة" عنوان مقالي السابق ("مبولة العالم"، "ملحق النهار"، العدد الفائت).
لقد كان العنوان فجّاً، صادماً، مقرفاً، مقزِّزاً، مثيراً للغثيان، زقاقيّاً، ومحطّ استهجانٍ منّي أوّلاً، خلال مخاض الكتابة، ثمّ من القرّاء، الذين لم يتحمّلوا دونيّته، ولا سوقيّته، ولا "رائحته". لكني، على الرغم من هذا كلّه، اخترته دون سواه من عناوين برّاقة، "مهذّبة"، ليخدش الحياء العام.
أقول للقرّاء: معكم حقّ.
ربما كان يليق بالأدب و"التأدب" أن يكون العنوان شيئاً مما كان يغمر لغة المقال، من مثل: "الحرية أرملة العالم". لا أخفي أني ترددتُ كثيراً قبل أن أنحاز إلى قسوة العنوان المستخدَم، مؤثراً، باعتذارٍ وتبكيتٍ عميقَين، أن يكون واقعياً، خالياً من التكاذب، والتقيّة، أشدّ لصوقاً بمعجم حقائقنا ووقائعنا الوجودية الفظّة، أكثر تظهيراً لكيفية تعامل المجتمع الدولي مع قضايانا، وأقرب إلى معجم القسم الكبير من طبقتنا السياسية، و"قطعانها" و"جماهيرها"، منه إلى المعجم الأدبي، الأليم والقاسي، لكن "المتأدب"، الذي أستخدمه عادةً في مقالاتي.
مختصَر ما قيل لي، من أصدقاء خلّص، تعليقاً على فظاظة العنوان، إنه كان ينبغي أن "أكتفي" بإيراد التعبير المستهجَن، في متن المقال فحسب، تخفيفاً عن القرّاء الذين يعانون ما يعانونه من جرّاء العيش الأبوكاليبتي.
معكم حقّ، أيها القرّاء والأصدقاء.
لكن "عذري" الوحيد لاستخدام هذه العبارة، أنها، في رأيي، واقعية تماماً، وصحيحة تماماً، بما يجعلها صورة رمزية ومعنوية (لِمَ لا أقول حسية؟!)، طبق الأصل، عن أحوالنا اللبنانية والعربية. شخصياً، لا أحبّ الاختباء وراء إصبعي، ولا تحت غشاءٍ عاهر للبكارة العقلية والأخلاقية، مدروز درزاً بالتقطيب والتجميل والإخفاء، من فرط ما تعرّض لاغتصاب الكرامات، ولإعادة الرتق، بمهانة وخبث و... طهارة لفظية، مصطنعة وكاذبة. فأنا لا أُحسِن الكتابة المخصيّة، ولا سياسة الإيماء الغامز، ولا المجاملة، ولا أستسيغ المداورة، مفضّلاً، على ذلك كلّه، الصدقَ الأدبي (أو اللاأدبي) الفجّ الذي يعذّبني، أكثر مما يعذّب القرّاء، لكنه يصف واقع الحال ليس إلاّ.
مع هذا الصدق، أكتب هذا التساؤل العاري، المفعم دائماً بالاعتذار النبيل: إذا لم تكن مبولة هذه التي نعيش فيها، فهل يكون في مقدور أحدنا أن يتوهّم أنها قد تكون بحيرةً لازوردية، أو جنّة؟
معكم حقّ، أيها القرّاء.
لكنْ، أعيروني وصفاً صائباً، "يليق" بحياتنا وأوطاننا السعيدة هذه؟
* * *
ستوب! الوصف "المهين" آنفاً، لا يُغني عن الموقف. فنحن لن نرضخ لحقيقة "المبولة". ولن نرضخ لليأس، مهما يطل الأمد. موقفنا مبدئي لا رجوع عنه، في الحرية والحداثة والنقد، وإن على طريقة سيزيف. فسنظلّ نحفر الصخور، صخور الخلق والعقل والرأي والمجازفة والمغامرة والشجاعة والصدق، ونحملها إلى فوق، إلى أن يتفجر نبع الحرية، ليشرب منه لبنان، الماء الزلال، وتشرب معه الشعوب العربية في سوريا والعراق ومصر وفلسطين، ما تستحقه من ماء زلال، في طريقها إلى الخروج من نفق الاستبداد إلى ضوء الديموقراطية والحرية.
هذا ما يليق بنا، بكتاباتنا، وأوطاننا،... وبالقرّاء على السواء.
* * *
بأيّ حياةٍ نَعِد الذين ماتوا قبل أن يصبحوا أطفالاً وعصافير؟
كنّا كلما فتّحوا عيونهم، نروح نتجنّب محادثة العصافير لأنها قد تؤلم عبورهم إلى الصباح. وكنّا كلّما أشرقتْ ضحكاتهم، نروح نؤثر عدم رؤية الصباح لئلا نفسد عليهم متعة الاستفراد بالعصافير.
كانت أعمارهم تسأل ماذا ينبغي لهم أن يفعلوا لكي يكثّروا هديل الضوء. وكانوا يعجبون كيف تستطيع الأرض أن تتحمّل أوزار الجبال، وكيف للجبال، لهذه الجبال بالذات، أن تتحمّل أوزار السماء، ثمّ كيف للغيوم الصابرة على نكران نشواتها، أن تظلّ تتحايل على شغبها الجنسي، وأن ترجئه بالكبت إلى كلّ شتاء.
كان جمرهم ينبئ بحطب أقدارهم، لذا كان عليهم ربما أن يحترزوا قبل أن تعقد الكوابيس أواصرها، وقبل أن تفاجئهم النيران وهي آخذةٌ بالقلوب من شغافها.
عندما اكتشفوا بعد فوات الأوان أنه لم يعد ثمة موضعٌ لإخفاء ما كان يتسرّب من الليل، لم يدركوا ما ينبئ به وجه الملاك الهارب من الحريق، ولا ما يُبكي رسوماً تجثم على جدار.
كانوا يوهمون خيالاتهم بأنهم سيعثرون على ما يكفيهم من قمح ليتيحوا للعصافير أن تشقّ لهم دروباً في فضاءات العيش والرغبة، لكنهم حين كانوا يعودون من غاباتهم مطأطئي الأيدي، كان ثمة في أعمارهم وفي عيون العصافير ما يبكّي الساهرين على دمل الجروح.
كانوا يجيئون من البراري، تاركين في عبورهم براهين تسعف الشمس في خطواتها المتعثرة. كان ثمة على أيديهم عطورٌ مقمرة وفي عيونهم ما يشبه الينابيع. كم كان عليهم أن يحاوروا الهواء قبل أن تعصف الغيرة بأشجار الحور. وكم كان ينبغي لهم أن يستمتعوا بالسهول قبل أن يأخذهم التيه الأسوَد إلى أوقاته المهلكة.
كنّا مطمئنين لاعتقادنا أن لا سبب يحول دون استدعاء الفجر كلما هبّت عطورهم على مقربة من نوافذ البساتين.
عندما سألنا الأمهات أن يملأن الأباريق ماءً، لم يكن في البال أنهنّ لن يعثرن على ماء. كان الشقاء قد استبدّ بالينابيع فنشّف أوتارها وترك للخيال أن يستكمل تخريب المرايا.
كان ثمة على الطريق ظلالٌ تستغيث، لكن أحداً لم يتوقف لينتشل الظلال في عبوره الهارب إلى السماء.
* * *
هل يمكن أحدنا بعد الآن أن يكون مترفاً فينام كملاكٍ هارب من أتعاب النهار؟ وإذا حقّاً غافلْنا النعاس، ونمنا، فبأيّ صباحٍ نحلم، وبأيّ أطفالٍ وعصافير؟ وإذا عشنا، فبأيّ حياةٍ نعِد الذين ماتوا قبل أن يصبحوا أطفالاً وعصافير؟!


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية