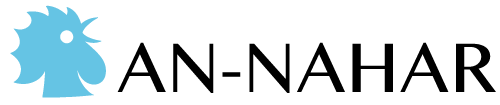بعد الحرائق، ربما لن يبقى في بلادنا الشيء الكثير مما يُعتدّ به. وحدها مدن الكتب قد تُكتَب لها النجاة. ليس لأنها لا تحترق. بل لأن حريقها يضمّد جمراً من شأنه أن يأوي إلى مواقد العقول غير القابلة لتأجيج الغرائز. بعد الحرائق، قد تنطفئ كتبٌ كثيرة، لكن لا بدّ أن يطلع من حبرها المرمّد ضوءٌ يطفئ بجروحه، هذا الكثيف الكثيف من الظلام الكابوسي المقيت.
روى لي صاحب مكتبة قديمة، كان يؤجّر الكتب للعائلات القارئة في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، في إحدى بلدات الشمال البحرية، أنه كلّما زاره أحدهم في دكّانه العتيق لاستئجار كتاب بهدف مطالعته، كان يشعر أن عمراً جديداً يضاف إلى أعماره المجمّعة كتاباً فوق كتاب، وصفحةً في ظلّ صفحة. وأنه، بدل أن يشعر بالشيخوخة من جرّاء تلك الأعمار، كان يزداد فتوّةً، ويمتلئ يقيناً بأن لا فناء قريباً له، بسبب أعماره المضافة، التي تنفض غبار الأيام عن جسمه المترهل، كأنها تجعله يولد من جديد.
كان ذلك الرجل شخصاً غفلياً للغاية، مقيماً في التواضع البسيط، والمجهولية، بمعنى أنه لم يكن ذا شهرة اجتماعية مرموقة، إنما قيمته المكتبية كانت تضفي عليه جاذبيةً شعبية لا يملكها إلاّ قلائل من الناس، وتمنحه مكانةً لطالما كانت موضع احترام في تلك البلدة البحرية.
كان كلٌّ من والدي ووالدتي يطلب منّي في صغري أن أذهب إليه لأستأجر الكتب، التي كانت تُقرأ مداورةً بين الأهل والأولاد جميعاً. لكأن الكتب تلك، كانت رغيفنا الكهنوتي العائلي الذي لا بدّ من تقاسمه والاشتراك في قربانه، باعتباره قدّاسنا السرّي.
كنتُ كلّما زرت الدكّان، وأجلتُ عينيَّ في رفوفه المغبرة، وظلاله الملتبسة، التي تزيدها التباساً أضواء قناديل الكاز، وأطيافها الرجراجة، ازددتُ رغبةً في أن أصير كتاباً تلتهمه العيون، وتترك الأيدي بصماتها ومشاعرها وهواجسها على صفحاته الغامضة. وقد ترسّخ "إيماني" مع الأيام بأن الكتب هي وحدها التي تدلّ، وتخترع، وتفتح الحلم، أمام الذين تتوالد أحلامهم، وتتجوهر، على الصفحات المضمخة بالحبر.
لا أزال أذكر أن روايات جرجي زيدان التاريخية، والروايات الروسية المترجمة، وكتب الرحّالة والمستكشفين الأجانب، إلى مؤلفات جبران وفؤاد سليمان وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وطه حسين وإحسان عبد القدوس، فضلاً عن روايات بيار روفايل الغرامية، كانت موضع تنازع بيننا في البيت، على نقيض ما هو عليه التنازع اليوم، حيث الكتب الصفراء والقيم والأفكار الصفراء، ومثيلاتها الجمّة في الإعلام المرئي والمسموع والافتراضي على السواء، هي التي تكاد تستأثر باهتمامات الرأي العام، فضلاً عن الناشئة وأهاليهم، معاً وفي آن واحد.
عندما كان عليَّ أن أترك، صباح كلّ يوم، تلك البلدة البحرية لأتابع دراستي الثانوية في مدينتنا الشمالية الكبرى، رأيتني أكتشف هناك، تلك المكتبات المهيبة، التي كانت بيوتاً لأصحاب الأفكار المدينية والحداثية والعلمانية، ولروّادها من الشيوخ والفتية المتطلعين إلى ما كان يعتري العالم آنذاك، من أحلام تغييرية، لم تنته جميعها إلى الطرق المسدودة، كما هي تقريباً، أحلامنا، في هذه اللحظة التاريخية المتحشرجة.
لم تكن مكتبات ذلك الزمان وقفاً على الأوساط المترفة، والشوارع والأحياء الأنيقة، بل كانت في جوهر الأمكنة، في صميمها الشعبي، وفي نسيجها المجتمعي العفوي الخلاّق. كنا نرتادها، حيث هي، وكانت فاعليتها فينا توازي فاعلية الهواء الذي يتسلل إلى الأرواح والضمائر والأفئدة، بدون كثير اجتهاد أو افتعال.
في ما بعد، تعرّفتُ إلى مكتبات الهواء الطلق، في ساحة البرج، وأمام مبنى اللعازارية، في عشايا الحرب اللبنانية. كانت تلك، تجربتي الأولى مع الحرية في معناها الأعمق والأشمل، حرية اللغة، وحرية الجسد، وحرية الفضاء، وحرية الحرية.
هناك اشتريتُ كتب محمد الماغوط وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا وأدونيس، وأعداد مجلة "شعر"، و"لبنان الشاعر" لصلاح لبكي، وسواها. هناك، في محيط ساحة البرج، كما في محيط شارع الحمراء، وخصوصاً في محيط منطقة الأونيسكو، وكلية التربية، انصنع كتّابٌ وكتبٌ ومكتبات، لا نزال نتقاسم أرغفتهم الساخنة. هذه تجربةٌ تحتاج وحدها إلى مرويات دؤوبة يجب توثيقها، ووضعها في تصرّف أبناء هذا الجيل، لعلّها تعطيهم فكرةً عن ثقافة بيروت ذلك الزمان، وعن طقوسها، وكتبها، ومقاهيها، ومناقشاتها، وفتيانها. ففي بيروت الحمراء، وفي غيرها من "الحصون" الثقافية المنيعة، في نواحي عاصمتنا، شرقاً وغرباً، وضواحي، تعرّفتُ إلى روح المكان الحقيقية، ولن أنسى أني اشتريتُ كتاباً لوديع سعادة من يده، "ليس للمساء أخوة"، حيث كان يقف على ذلك الرصيف البهيّ في الحمراء، فكان هو الكاتب، وهو الكتاب، وهو المكتبة.
اليوم، إذا أراد أحدنا أن يبحث عن الممانعات الروحية والثقافية الحقيقية، فليس عليه سوى أن ينزل سلالم ملتبسة تفضي إلى أمكنة تحتية في شارع الحمراء، ومتفرعاته، كأنها البنى اللاواعية للمكان، أو كأنها ينابيع مضمرة تمنح المدينة بعض روائها واخضرارها في غمرة الباطون العقلي المسلّح الذي يستولي على أفكار ساستها، وزمرها الطائفية والميليشيوية، كما على سطحها وسديمها والأديم.
لا لزوم للتعداد، ففي أكثر من موضع وتكّية، لا تزال عاصمتنا هي المكتبة. لن أخوض في التبجّح، فالوقت وقتُ ألمٍ مكابر، متواضع، ومتحفظ، وليس وقت ادعاء. لكنْ، ينبغي لنا، والحال هذه، أن نترك الواجهات قليلاً، وأن نتدروش، لنذهب إلى الأروقة والغرف الخلفية، والتتخيتات، والتكايا، وإلى أندرغراوند المدينة الثقافية، حيث لا سفلة ولا قتلة، ولا جلاّس للتآمر، بل ثمة الورّاقون، وعشّاق الغبار الأنيق، وثمة الكتب ورفوفها، وهواجسها، وهؤلاء شرف عاصمتنا، وسؤددها العظيم.
أعرف، بالتواتر، مكتبةً تاريخية، عتيقة وحديثة، في وسط المتن الشمالي، يزورها، بانتظام، كبيرُ أخوتي وأخواتي، لتصفيف شَعره لدى صاحبها. فهذا الرجل، إلى كونه حلاّقاً، عارفٌ نهم، ومثقفٌ جائع إلى معرفة، لا يفوت رفوفه المكتبية ديوان شعر مرموق، ولا رواية ليوسف حبشي الأشقر بالطبع، ولا للروائيات والروائيين الجدد أو المخضرمين. في صالون الحلاقة، هناك، تُدار الأحاديث بين صاحب الصالون وبعض زوّاره من القرّاء والأدباء والأكاديميين، بينهم شقيقي، على الإصدارات الطازجة، والمعايير النقدية، وعلى الاتجاهات الأدبية الحديثة، إلى أسئلة تتعلق بما يمكن أن يكون قد فات صاحب الصالون – المكتبة من عناوين لم يُتِح لها الترويج الإعلامي أن تصل إلى رفوفه. وإذا خرجت الأحاديث على حدودها الأدبية، فإنما ليسأل صاحبنا عن سلّم القيم ومآلاته في هذا الزمن الصعب، وليقارن بين رجالات السياسة، الآن، وأولئك الرجالات من صنفٍ قيمي وأخلاقي ورؤيوي "منقرض" تقريباً، كريمون إده مثلاً. لا يفوت صاحب المكتبة أن يسأل مراراً وتكراراً عن أحوال الاختصاصات الجامعية الأدبية راهناً، وعما يمكن أن تؤول إليه الكتابة الخلاّقة على وقع التداخل بين العوالم الافتراضية والواقعية.
حملني الفضول يوماً، على زيارة تلك المكتبة – الصالون، لا لتصفيف شعري، بل لأصافح ذلك الرجل "المنقرض" الذي بالكاد نجد له أمثلة نادرة في ثقافتنا المنجرفة إلى مصائرها المجهولة. لم أفاجأ بأسئلته التي تستفهم عن هذا الكتاب أو ذاك الديوان، بل فاجأني أنه يقرأ كثيراً، ويسطّر كثيراً، وأنه يعرف، بالتأويل والتحليل، عن أمثالي، وعن كتب أمثالي، ما قد لا يعرفه الواحد جيداً عن نفسه وأدبه.
لم يُعطَ لي أن أعايش نماذج من مكتبات نواحي صيدا العتيقة، وجبل عامل، كما زحلة البقاع، وسواها المنثورة في الدساكر والقرى. إلاّ أن هذه المعايشة يعرفها كثرٌ غيري، وفي إمكانهم أن يسردوا وقائعها ومروياتها، ساعة يشاؤون. بل يجب أن يفعلوا ذلك، هنا، وحيث يرغبون. منابرنا كلّها يجب أن تكون للكتب والمكتبات، لا للغربان والقتلة.
الحاضر يحترق. الحياة تحترق. وحدها ذاكرة الكتب ستنجو من الحرائق.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية