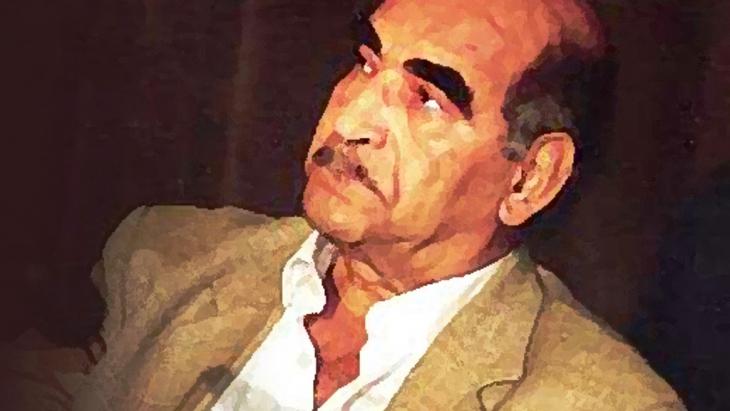مفهوم الديموقراطية ومقوماتها وعلاقتها بالعلمانية ومدى الترابط والتلازم بينهما، يبقى الأكثر التباساً وإشكالاً في الخطاب السياسي العربي الراهن، مع أنه كان الأكثر تداولاً في هذا الخطاب منذ الربع الأخير من القرن الماضي.
غالباً ما طرحت الديموقراطية منزوعة من جذورها الفلسفية ومن فضائها التاريخي العلماني لتتحول لدى بعض الذين نادوا بها آلية انتخابية عددية مفرغة من مضمونها الليبرالي الذي هو أصلها وجوهرها.
ووجد هؤلاء في هذا المنحى الأيديولوجي الذي بات مألوفاً في الخطاب السياسي العربي الراهن، مخرجاً للتنصّل من مرتكزات الديموقراطية وموجباتها القائمة على حرية الفرد ومركزيته وحقوقه الطبيعية ومرجعيته المطلقة في التشريع والسياسة، وعلى المساواة السياسية العامة بين أفراد المجتمع من دون تمييز أو تفريق.
مجردة من كل هذه المرتكزات والقيم يتمسكون بالديموقراطية بل يضفون عليها الأصالة والقدسية باعتبارها قيمة من تراثنا الذي قال بالشورى والاحتكام إلى الرأي الآخر، ويرفعونها من ثم إلى مرتبة أخلاقية متقدمة على ديموقراطية الغرب التي شرّعت على ما رأى راشد الغنوشي في "أزمة الديموقراطية في البلدان العربية"، المظالم والفواحش والعدوان والفسوق والفساد والضلال.
وقد يذهب بعضهم إلى أنّ قيم الحرية والمساواة والتسامح والتطوع والقبول بالتعدد والاختلاف في الفكر والرؤى والمصالح التي تشكل الأركان الأساسية للديموقراطية وللمجتمع المدني كما نشأ في الغرب، هي من صميم الإسلام تؤكدها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، على ما رأى حسنين توفيق إبراهيم في "النظم السياسية العربية".
وتبعاً لهذا المنحى يمكن تجزئة الديموقراطية، وتقبل آلياتها التقنية الانتخابية، وإن "مستوردة من الغرب" وترفض مضامينها الفلسفية والأيديولوجية المرتكزة في الأصل والجوهر على المواطنية والعلمانية والمساواة وقدسية الفرد.
وهكذا فالاقتران بين الديموقراطية والعلمامية، في رأي الغنوشي، مضلل، روّجه غلاة العلمانية في وسط قطاع من الإسلاميين مستغلين ضعف تكوينهم في الفكر السياسي والفلسفات المعاصرة، فقد تكون الديموقراطية من دون علمانية، وقد تكون العلمانية من دون ديموقراطية.
لكنّ محمد عابد الجابري في "في نقد الحاجة إلى الإصلاح" ذهب أبعد من ذلك، إذ يقول "طرحت مسألة العلمانية في العالم العربي في القرنين الماضيين، طرحاً مزيفاً، بمعنى أنها أريد منها أن تعبر عن حاجات معينة بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات... من أجل هذا نادينا منذ الثمانينات من القرن الماضي بضرورة استبعاد شعار (العلمانية) من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري (الديموقراطية) و(العقلانية) لأنهما يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي. الديموقراطية تعني حفظ الحقوق، حقوق الأفراد وحقوق الجماعات، والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية والدينية عن العقل ومعاييره المنطقية والأخلاقية ... ومن جهة أخرى، فإنه لا الديموقراطية ولا العقلانية، يعنيان بصورة من الصور استبعاد الدين".
يمثّل هذا النص للجابري أنموذجاً للالتباس المفهومي في الخطاب السياسي العربي الراهن، إذ يعمل تصوّر ملتبس لمفهوم ما على إعادة تشكيل الشبكة المفهومية بالكامل تشكيلاً ملتبساً تختلط فيه المعاني والأهداف والتصورات وتضيع البوصلة الموجهة للرؤية الأيديولوجية والفلسفية الكامنة في المفهوم ذاته، وما تنطوي عليه من مبادئ وأحكام واستنتاجات ملازمة. فهل كان الطرح العلماني بالفعل طرحاً مزيفاً عبّر عن حاجات معينة بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات؟ وهل العلمانية مقرونة ضرورة بالإلحاد؟ وهل يمكن الفصل بينها وبين الديموقراطية؟
أسئلة يثيرها طرح الجابري بالجملة، ليعبر في النهاية عن تصوّر مسبق مقرر منذ البدء يهدف إلى التعامل مع الديموقراطية كآلية انتخابية ليس إلا، وإزاء هذا الموقف لا مناص من أجل فصل مقال في ما بين الديموقراطية والعلمانية من الاتصال، من الرجوع إلى المفاهيم المؤسسة للعلمانية والديموقراطية، أي مفاهيم الفرد والعقد الاجتماعي والمجتمع المدني، التي جاءت بها ثورة الحداثة في الغرب، وعلى أساسها قام مفهوم الإنسان والمواطن الذي شكّل الديموقراطية وقاعدتها.
الديموقراطية التي قامت على هذا الأساس الفلسفي التاريخي لا تقتصر على مجرد آلية انتخابية مبنية على مبدأ الأكثرية والأقلية، فقد تتحقق هذه الآلية على أكمل وجه، من دون أن يفضي ذلك بالضرورة إلى الديموقراطية.
لكي تكون ثمة ديموقراطية يجب أن تتوافر شروط ومبادئ أساسية أغفلها موقف الجابري، وأولها الاعتراف بالفرد الإنساني ومركزيته السياسية والاجتماعية. وثانيها قيام النظام السياسي على عقد اجتماعي يختاره أفراد المجتمع بإرادتهم ويلتزمون به طوعياً. وثالثها المساواة التامة بين أفراد المجتمع في المواطنية والحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو المذهب أو الطائفة.
لقد فات الجابري أن هذه الشروط والمبادئ التي تشكل جوهر الديموقراطية لا يمكن تحققها من دون العلمانية التي تفصل بين الفضاءين الديني والسياسي. ففي الفضاء الديني مصدر الحكم والشرائع إلهي لا بشري، والفرد يتعين بانتمائه الديني لا الاجتماعي والمواطني، وحقوقه وواجباته لا تتحدّد بعقد اجتماعي بل بنص منزل لا يقر بالمساواة التي تصر عليها الديموقراطية، إن بين الرجل والمرأة أو بين المؤمن وغير المؤمن أو حتى بين المؤمنين أنفسهم.
من هنا يبدو الفصل بين الديموقراطية والعلمانية أمراً لا يمكن تصوّره أو قبوله. أولاً لأنهما متلازمتان في الانتماء إلى فضاء الحداثة الذي دشّن أفقاً إنسانياً مختلفاً في الجوهر والرؤى والتطلعات، عن الأفق المرسوم في المنظور الديني. وثانياً لأن الديموقراطية من دون العلمانية تستثني فئات واسعة من الجماعات التي تشكّل المجتمعات العربية، المؤلفة أساساً من جماعات متعددة الانتماءات الدينية والمذهبية والطائفية والإثنية.
أما ربط الجابري العلمانية بالإلحاد وقوله إن العلمانية إنما "أريد بها التعبير عن حاجات معينة بمضامين غير متطابقة مع تلك الحاجات"، فلا مسوّغ له ولا شرعية، إذ ليس ثمة تعارض بين الإيمان الذي هو علاقة بين المؤمن والخالق، وبين التنظيم السياسي الاجتماعي الذي هو شأن دنيوي أساسه العلاقة بين الإنسان والإنسان أو بينه وبين المجتمع.
كما أن الإلحاد لم يكن وارداً - باستثناء أفراد قلائل – في أذهان العلمانيين العرب الذين أرادوا من خلال الدعوة العلمانية تجاوز واقع الانقسام والتمزّق الديني والمذهبي والطائفي القائم في المجتمعات العربية، إلى الانتماء المدني والوطني والقومي الذي يرتقي بالإنسان العربي إلى آفاق التقدّم والحداثة وينهي النزاعات المتجددة والحروب الأهلية المتوارثة.
وهذا ما كان حاضراً في أذهان العلمانيين العرب الرواد من بطرس وسليم البستاني وفرنسيس المراش، إلى فرح أنطون ونجيب العازوري الذين آلمهم صراع الطوائف وزج المبادئ الدينية السامية في هذا الصراع، وتسخيرها لـ"أغراض ومصالح خصوصية" بلغة الرائد النهضوي العلماني فرنسيس المراش.